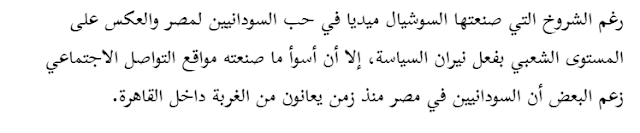الشاعرة تريتر: تتفوق على نفسها في ابتكاراتها الشعرية
.
.
أشعل معي الأنهار
موسم نايِها قد لا يجيءُ
فكن لها الأغياثَا
.
الملحُ
يعرفُ لهفةَ الماء اللَّذي .....
مُدنًا تؤدِّب في الحنين لُهَاثَا
.
الحزنُ
يشربنا انتظارًا عاجزًا
لتصومَ أوقاتُ اللِّقاءِ ثَلاثَا
.
لا أعرف اللَّونَ (الرَّمادَ)
فلا تكن صوت الرَّمادِ
ودع ليَ الْمِحْرَاثَا
.
أنضجتني
حتَّى اكْتَملْتُ قَصِيدَةً
هل أشتهي عندَ الحصادِ بُغاثَا
.
كفَّاكَ مقبرةُ الورودِ
قيامتي اقتلعتكَ
من خلف النَّدى أجداثَا
.
أنا لن أموتَ
ولن أريكَ خزائِنِي
حتى تقسِّمَ لهفتي ميراثَا
.
خيَّالة قلبت على مِضْمارِهَا
خيَّالَها
وتعطَّرت أحداثَا
.
إترك ليَ الأحلامَ
كمْ أنزلتها
ولتنزلنَّ وإن أتت أضغاثَا
.
إن ما يميز النسق التعبيري عند الشاعرة: (إبتهال تريتر) وفق تقديري الخاص هو صعوبة التغلغل في تفاصيله، والوصول إلى محتواه إلا على النخبة الأدبية، القادرة فعليا على تتبع جمالياتها الكتابية بروح محبة وعقل متفتح، وهذا الأمر لا يقدح في قابلية وصول هذه الكتابات إلى المتلقين بشكل عام، ولكنها فعليا تحتاج إلى (مخمخة) تدبرية، و(سلطنة) عقلية ووجدانية ليست متاحة عند كثير من محبي الشعر، وهو أمر يجعل الشاعرة في خانة خاصة ومميزة لا يزاحمها فيها غيرها من المعاصرين لها شعريا.
.
وحول قراءتي المتواضعة لنص الشاعرة أعلاه في نسق آخر فإنني أستطيع القول: إن القافية (الثائية) في القصائد العربية دائما ما تتصاحب مع روح العرامة الشعرية المهيبة، وعنفوان الرصانة وتوهجها، ونادرا ما تأتي معبرة عن معانٍ رقيقة الحاشية وحميمية الإيحاء، كما هو حاصل أمامنا في هذا النص الشعري المتفرد، الذي يمكننا اعتباره معزوفة شعرية نادرة تفوقت فيها الشاعرة (ابتهال تريتر) على نفسها وهي تبتكر تعابيرها فيه، وتستحدثها من نبع مخيلتها الخصبة بصورة تجديدية أنيقة.
.
وقد تحكمت الشاعرة تريتر منذ البداية بمكنونات لغتها الشعرية، حينما جمعت كلمة (غيث) بلفظة (أغياث)، ولم تستعمل لفظ (غيوث) رغم إمكانية ذلك وفقا لقاعدة جمع التكسير المعروفة، ولعلها روح الضرورة الشعرية التي جعلتها تختار أبعاد هذه القافية الجزلة وموسيقاها النابضة هكذا: (آثا).
.
وقد ابتدرت رحلتها الخيالية في هذا النص المتوهج بطلبها ممن تتحدث إليه إشعال الأنهار معها (أشعل معي الأنهار)، وإشعال الأنهار أمر مثير في حد ذاته سواءا واقعيا أو مجازيا، معللة هذا الطلب باحتمالية عدم مجيء موسم (ناي) الأنهار، وبالتالي خوفها من جفاف ألحانها المفترض، لذلك طلبت ممن تخاطبه أن يكون (أغياثا) تمد الأنهار بالماء وباللحون وبالمحبة:
أشعل معي الأنهار
موسم نايها قد لا يجيءُ
فكن لها الأغياثَا
.
ثم تستطرد قائلة: إن (الملح) يعرف (لهفة الماء) تماما كما تعرف (المدن) الحنين، وتؤدب فيه (اللهاث) المتمرد، والحقيقة أن تعبير تأديب المدن للهاث الحنين تعبير مبتكر ومتوهج، يثير حفيظة الخيال التأملية عند القارئ، ويستفز المتلقي خصوصا عندما تركت له الشاعرة فرصة تحديد ما يفعله الماء في الشطر الأول من البيت بفراغ ممتد وجدانيا، وذلك عندما قالت:
الملحُ
يعرفُ لهفةَ الماء اللَّذي .....
مُدنًا تؤدِّب في الحنين لُهَاثَا
.
ثم جعلت من نفسها في الشطر الأول من البيت التالي عصارة من الإنتظار العاجز حتى يشربها الحزن، والإنتظار في حقيقته هو انتظار عاجز دائما، ولكنها اختارت أن تقر بهذا الأمر شعريا، لعل انتظارها ينال بعضا من القدرة، أو يحظى بشيء من القوة في مواجهة أحزانها المتصلة، من قبل أن تحنث أوقات لقائها بقسمها وتصوم ثلاثا تكفيرا عن هذا الحنث، وهو تعبير استقته من ثقافتها الدينية البحتة، عند استلهام كفارة الحنث باليمين كما هو معروف، لكنها تركت الباب مواربا لتحديد طبيعة الصيام التكفيري في حالة أوقات لقائها الحانثة بقسمها:
الحزنُ
يشربنا انتظارًا عاجزًا
لتصومَ أوقاتُ اللِّقاءِ ثَلاثَا
.
وفي البيت التالي تصر الشاعرة على إخبارنا جميعا بطبيعتها الغير محايدة، والغير مجاملة أو متلونة حينما تصرخ بأعلى صوتها قائلة: (لا أعرف اللون الرماد)، وتطالب من تحاوره في أبياتها هذه بأن يكون مثلها، وينأى بنفسه عن المداهنة والتلون في قولها: (فلا تكن صوت الرماد)، فهي شاعرة (دُغْرية) وتجيد التعامل مع كيمياء اللغة بشكل جيد، وقد اختارت ذكر لون الرماد وصوته للتعبير عن فكرتها لقربها من المفهوم السائد في تراثياتنا الإجتماعية، والحديث يقودنا إلى البحث عن رائحة الرماد، حتى تكتمل معادلته الكيميائية في مخيلة جوارحنا:
لا أعرف اللَّونَ (الرَّمادَ)
فلا تكن صوت الرَّمادِ
ودع ليَ الْمِحْرَاثَا
.
ولعلها تستفز محاورها حتى يظهر ما يبطنه تجاهها من عواطف لا تقبل الحياد فيها، فهو إما يكون معها أو لا يكون، وقد طلبت منه بعد ذلك أن يترك لها المحراث، في نقلة مباشرة إلى بيئتها الطبيعية التي نشأت فيها، فهي بنت (الجزيرة) الخضراء، وربيبة (الحَوَّاشات) والحقول، و(التُرع) وقنوات الري وجداوله المتعددة، وهي تريد من صورتها الشعرية هذه إيقاظ ذاكرتها الطفولية الوادعة ومشاركتنا الإحساس بما تحتويه من جماليات ودفء، و(المحراث) أداة توحي بالقوة والعزيمة والمجهود والمثابرة واتخاذ الأسباب واختيار أفضلها في صناعة الحياة، ومن قوة إيحائاته المتعددة هذه نجد الشاعرة قد اختارته أحد الرموز الشعرية في نصها المتدفق كتدفق مياه (النيل الأزرق) في (مشروع الجزيرة).
.
ثم تستطرد شاعرتنا صناعتها للمشهد الشعري وهي لا تزال تستلهم إيحاءات بيئتها الزراعية المحضة، حين تقول لمن تخاطبه في نصها هذا: (أنضجتني)، وهنا نلاحظ بوضوح استعارتها لنضج الثمار كحقيقة بيولوجية، وإحالة هذا النضج مجازيا لعواطفها وأحاسيسها الوجدانية، فالأنثى دائما ما تجسد الأرض البكر في مخيلتنا، تلك الأرض التي تحتاج لمن يسقي بذرتها ويهتم بها حتى تؤتي أكلها وثمارها، والحقيقة أن نتيجة إنضاجها المجازية هنا قد جعلتها تتمرحل جماليا حتى اكتملت قصيدة شعرية شهية وفواحة:
حتَّى اكْتَملْتُ قَصِيدَةً
هل أشتهي عندَ الحصادِ بُغاثَا
.
وهنا تحديدا أستطيع أن أرى فزاعة الغريزة عند الشاعرة تنتصب قائمة في حقل روحها كـ (الهمبول) الكبير وهو يطرد (بغاث الطير) عن محصولها الوجداني، و(الهمبول) مجسم على هيئة إنسان (فزاعة) في ثقافة المزارعين السودانيين يصنع من مواد بسيطة، مهمته هي إخافة الطيور التي تتجنى على محصول المزارعين وتفسده قبل وصوله لمرحلة النضج وموسم الحصاد.
.
وبعد مشهد من أجمل مشاهد الحياة والخصوبة والتجدد، تلتفت الشاعرة إلى مشهد مناقض تماما وهو مشهد المقبرة والأجداث والقيامة في البيت الذي تقول فيه:
كفَّاكَ مقبرةُ الورودِ
قيامتي اقتلعتكَ
من خلف النَّدى أجداثَا
.
وفي تقديري ورغم قساوة التصوير الشاعري في هذا المشهد، وقتامة إيحاءاته وسوداويتها إلا أنه ضروري جدا بالنسبة للشاعرة لأنها تريد تصوير مقدار القسوة والتجني النابعة من طريقة معاملة من تحاوره لها، وعدم اكتراثه بها أو بمشاعرها بصورة أو بأخرى، فقد جعلت من كفيه مقبرة للورود، وهو تعبير مشحون بالمواجع ومملوء بالقسوة إلى أبعد حد، ثم انتقلت الشاعرة لتعلن أن قيامتها الداخلية قد اقتلعت محاورها من كف الندى كأنه مجموعة من الأجداث، والفارق اللغوي بين المقبرة وهي محل القبور وبين الأجداث فارق تحدده الروح البلاغية في القرآن الكريم، فقد وردت لفظة المقابر وهي جمع مقبرة في الآية الثانية من سورة التكاثر: (حتى إذا زرتم المقابر)، أما (القبور) فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم خمس مرات من أرادها وجدها، ويلاحظ أنها جميعا تحمل معنى واحدا للقبور، وهو الأماكن التي دفن فيها الموتى، وسواء تحدثت الآيات عن أن الله تعالى سيبعثهم يوم القيامة أو تحدثت عن بعثرة القبور يوم القيامة أو تحدثت عن أن سكان القبور لا يسمعون لأنهم موتى، فإن المعنى الثابت للقبور يظل هو المكان الذي دفن فيه الموتى، أما الأجداث فقد ذكرت ثلاث مرات في القرآن الكريم، وذلك في:
- (ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون) يس : 51 .
- (خشعا أبصرهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر) القمر : 7 .
- (يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون) المعارج : 43 .
ونلاحظ أن الآيات الثلاث هنا لم تتحدث عن موتى، بل تحدثت عن أحياء، لأنهم في آية سورة (يس) ينسلون، وفي آية (القمر) يخرجون وأبصارهم خاشعة، وفي آية (المعارج) يخرجون سراعا، وهذا يعني أن الأجداث لم تعد قبورا، ومن هنا ندرك الفرق بين القبور والأجداث، حيث القبور هي الأماكن التي دفن فيها الموتى، وأما الأجداث فهي نفس الأماكن ولكن بعد أن بُعِث منها الموتى وعادت إليهم الحياة مرة أخرى، وهكذا يتضح لنا كيف أن القرآن الكريم يراعي الدقة في التعبير بألفاظ مختارة بعناية كبيرة لا نجدها في تعبيرات البشر.
.
وقد أفادت الشاعرة تريتر من هذه الروح البلاغية العظيمة في القرآن الكريم، في حديثها الشعري المعبر، عندما ذكرت أن قيامتها قد اقتلعت محاورها كاقتلاع الأجداث من خلف ندى الحياة والبعث.
.
ثم تواصل حديثها عن عوالم الموت بروح يملؤها التحدي والشموخ قائلة:
أنا لن أموتَ
ولن أريكَ خزائِنِي
حتى تقسِّمَ لهفتي ميراثَا
.
ومن أروع ما ابتكرته من صور تعبيرية في هذا النص صورة اللهفة التي يمكن أن تجمع في خزائن الروح، وتصبح ميراثا مذخورا للمرء من بعد موته.
.
وتتابع الشاعرة حديثها المليء بعنفوان التحدي والشموخ حينما تقول عن نفسها بأنها:
خيَّالة قلبت على مِضْمارِهَا
خيَّالَها
وتعطَّرت أحداثَا
.
وبمثل هذه التعابير المبتكرة والمتوهجة في سماء الإبداع يمكننا أن نشعر بالعطر المنتشر من أحداث الروعة وأبعادها في خيال الشاعرة، وفي روحها الحالمة والمتطلعة لاقتناص كل ما هو جميل في عالم الأحلام وفي عالم الواقع:
إترك ليَ الأحلامَ
كمْ أنزلتها
ولتنزلنَّ وإن أتت أضغاثَا
.
.