القاصة السورية فادية عيسى قراجة
قالت حوَّاء : هل تذوقت اللذة عندما تتعطل لغة الكلام ؟ انتظر لا تجبْ ..
هل تعرف معنى أن تفقد الكلمة بكارتها ؟ انتظر لا تجبْ ..هل تجرعت طعم السم المدسوس في رضاب القبلة ؟هل جربت أن تنتحر على جسد من تحب ؟؟
دقق آدم فيما قالته حوَّاء .. فهاجمته بهذا الاعتراف : -
لقد فقدت بكارتي .. هل تسمح أن تخبرني متى فقدت بكارتك ؟ انتظر لا تجبْ .. أنا فقدت بكارتي منذ يومين ,منحتها لرجل يائس , جاء يتسولني , فلم أجد ما أهبه سوى بكارتي , الحقيقة كنت أريد أن أوفرها لليلة مجنونة تجمعني بك, أعرف بأنك تشتهي جسدي , وتموت شوقاً على الغرق في بئره البكر , ولكن هذا ما حصل ..كان الرجل محبطاً, بائساً , يتدفق ألماً , شهوته مطفأة, فض بكارتي مثل تلميذ يسرق
الواجب المدرسي من دفتر صديقه .. والآن عليك أن تخبرني منذ متى فقدت بكارتك ؟
حاول آدم أن يستوعب تلك القنابل التي قذفتها لكنها لم تسمح بأيّ لحظة تفكير , وقالت بتشدد:
- ما بك ؟؟ أين حماسك ؟ هل مضى وقت طويل على وداعك لبكارتك ؟
أيُّ مجنونة هذه الحوَّاء ! ماذا تخرِّف ؟ حاصرته بأسئلتها , وهددت باستعمال الأسلحة الخطيرة مالم يجب على استفساراتها ..
قال بصوته الحريري: لكنني رجل يا حوَّاء , عن أي بكارة تتحدثين ؟!
صاحت : رجل؟؟! حسناً .. سأعطيك عشر دقائق لتعترف ....
أحنى آدم رأسه , وبدأ يفكر ويحدِّث نفسه .. هي تقصد متى أول مرة تعرفت على جسد المرأة .. أنا أفهم هذه الحوَّاء الخبيثة .. كنت في الثانية عشرة من عمري .. حيّنا كان شعبياً , أو ما يسمى بالعشوائيات .. سكنتْ في حيّنا امرأة سمعتها سيئة أو هكذا اصطلحت على تسميتها نساء الحي.. كانت تقف على باب بيتها بثوبها القصير ذي اللون الأحمر القاني الذي يشف عن ملابسها الداخلية , كان الرجال يتلمظون حسرة ,
ويصبون جام غضبهم , وحنقهم وجنونهم على نسائهم .. مرة وقفتُ أمام بيتها فقد وقعت كرتي على شرفتها .. أدخلتني البيت , أعطتني حلوة لذيذة,أطعمتني بيديها .. قادتني إلى غرفة نومها .. تعرّت أمامي , وأشارت إلى نقاط في جسدها وقالت : ما أسم هذا, وهذا , وهذا ؟؟ بدأتُ أرتجف ,وأتصبب عرقاً , فاحتضنتني وبدأت بتعريتي , كانت أناملها تخدرني وهي تمسح جلدي الغض,و تشم العفاف في جسدي .. ومن ثم قادتني إلى جنتها الحارّة..امتصت روحي,وأخرجتني من غرفتها رجلاً حقيقياً ..
ومن يومها لم تغادر وجداني .. حفظتُ تفاصيلها , ورسمتها على دفاتري ثم ضاجعت الورق بألم ولذة , كان هذا سرّي السعيد .. وبدأت النساء تتوالى على فراشي بألوان وأحجام وأسماء مختلفة , لكن أي منهن لم تُبلغني تلك النشوة التي
منحتها لي امرأة سيئة السمعة ..
صرخت حوَّاء: انتهت الدقائق العشر.. هل يحتاج الأمر إلى هذا التفكير ؟
قال آدم : هل تجيبين على سؤالي بصراحتك المزعومة؟
ردت بتأفف : اسأل
جلس آدم القرفصاء , وسدد سهامه على وجه حوَّاء الفاتن :
- كيف فض ذلك الرجل بكارتك؟
ابتسمت حوَّاء وتمتمت:
- مثلما يفعل كل الرجال
قال آدم : وأنت؟؟ هل تعريت ِ له ؟ هل شم رائحة جسدك ؟ هل مسح جسدك بشفاهه ؟هل خرج من غرفتك رجلاً حقيقياً, أم أنه دخل متسولاً , وخرج متسولاً ؟؟
قالت حوَّاء : في الحقيقة لم أخلع ملابسي .. لكن لماذا هذه الأسئلة ؟
أردف آدم : لماذا لا تسعدنا إلا امرأة سيئة السمعة, تقول أنا جسد , أنا للمتعة , أنا للفراش فقط , أنا للّحظات الخالدة ؟؟هل لأنها تعطينا مفاتيح الجنة وتعرف نقاط ضعفنا نطلق عليها هذه التسميات , ثم نقتلها وهي من تصنع منا رجالاً ؟ لو كنت يا حوَّاء سيئة السمعة كنت أسعدت ذلك المتسول الذي وهبته بكارتك لكنك فشلت في أداء هذا الدور الذي لن تتقنه سوى امرأة تلبس ثوباً أحمر , وتقف على باب بيتها , تتعرى أمام طفل غرير, ثم تلقنه أسماء أعضائها عضواً , عضواً .. حتى أنه لم يجد
في أيّ امرأة ما وجده في تلك المرأة التي قتلتها نساء الحي لأنهن فشلن فيما نجحت به , فهي الحياة التي نقتلها , وهم الموت الذي يعشش في العشوائيات ..
فكرت حوَّاء فيما قاله آدم, وخصوصا الشق المتعلق بها .. هي جميلة جداً فلماذا أسرع ذلك المتسول في مهمته , وخرج دون أن يثني على شيء فيها , حتى لم يقبّلها , كان منهمكاً في تمزيقها بأسنان تشرده ..
تكومت حوَّاء مثل قطة قرب آدم .. التصقت به .. ثم وضعت يديها على وجهها وأجهشت بالبكاء ..
لم يتحرك آدم من جلسة القرفصاء .. أشعل لفافة تبغ .. وبعد أن انتهى منها داسها بقدمه, ثم خرج .

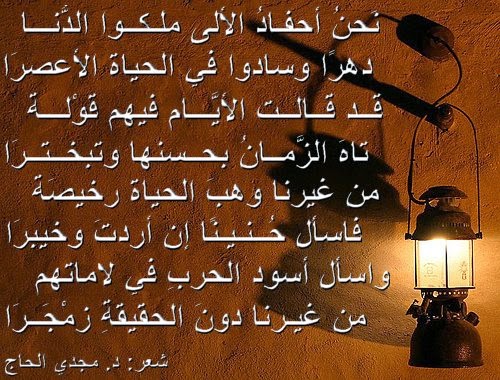
.jpg)






